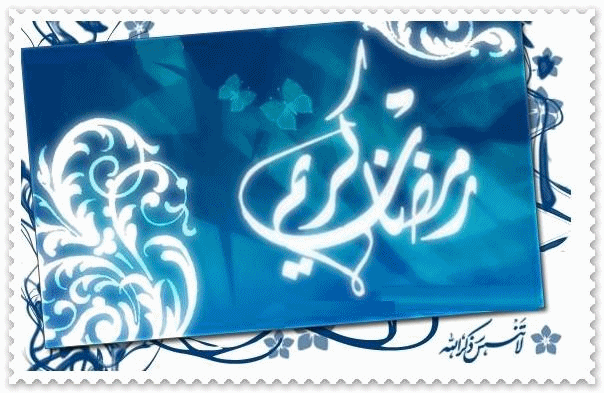الأسبوع الماضي صدرت عن الأمم المتحدة دراسة ''التغلب على انعدام الأمن الاقتصادي[1]''. حذر التقرير بقوة من مغبة استمرار كثير من الدول النامية اعتماد أسطورة الأسواق المنظمة ذاتيا التي ترسخت فكرتها في أواخر القرن العشرين. تحت يافطة تحرير الأسواق أطلق عنان قوى المنافسة والمجازفة بلا حدود. وتم الادعاء بأن الإجراءات المتخذة على هذا الطريق ستساعد الأسر على الاستجابة بصورة أفضل لإشارات السوق وتقلل من تقلب الدخل والاستهلاك، ما سيؤدي إلى استتباب الأمن.
ومنذ آدم سميث قيل بإن الأسواق لا تنتظم بذاتها. وبينت تجربة ما بين الحربين العالميتين أن الأسواق غير المنظمة تكون أميل إلى التدمير الذاتي منها إلى التنظيم الذاتي. وبينت التجارب أن تدابير ''معالجة الصدمات'' أدت إلى تحميل الكثير من ضغوط الأسواق وأعبائها على الأفراد والأسر المعيشية مقابل القليل من التدابير الحكومية التعويضية[2]. وحيث ساد وهم أن أسعار الأصول ''لا يحركها التحسن في توقعات مكاسب أو خسائر الدخل بقدر ما تحركها التوقعات الخاصة بتغيرات الأسعار[3]''، ففي هذا السياق عادة ما يستهان بمخاطر التقلبات الدورية في فترات الازدهار ويبالغ تقديرها في فترات الركود. لذلك فإن جل ما تسفر عنه فترات الطفرة المالية استثمارات غير متوازنة لا تعني أكثر من إعادة ترتيب الأصول القائمة عبر عمليات شراء الأسهم بتسهيلات إقراضية ثم إعادة شرائها، والدمج والحيازة والقطاعات الخاضعة للمضاربة كالممتلكات [4]. كما أدى حصول الأسر المعيشية على الائتمان إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي حتى في ظل ركود الدخول.
مقابل ذلك تشير الدراسة إلى أن البلدان النامية الناجحة لم تلجأ إلى السوق الذي ينظم ذاته في رسمها لاستراتيجياتها الإنمائية. بل أمنت نموا سريعا عن طريق مزيج من الحوافز السوقية والتدخلات القوية من جانب الدولة. وقد ساعدت التدابير الاقتصادية ذات الصبغة الاجتماعية على تنشئة طبقة محلية من منظمي المشروعات. وقد حكمت الرؤية الشاملة للتنمية تدخلات السياسة العامة في تنويع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من الفقر[5].
وتتقدم الدراسة بنصيحة ذهبية لبلداننا على المستوى المالي بأن ''من الضروري إعادة إحياء تدابير الاقتصاد الكلي والأنظمة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية. ويعني ذلك عدم إمكانية المضي في تنظيم الهيكل المالي الدولي وفق مبدأ الحرية الاقتصادية الذي وسع نطاق الوصول العالمي إلى الأسواق المالية دون إرساء قواعد وموارد وأنظمة عالمية مناظرة، حيث يعتبر سد هذه الفجوة أولوية ملحة[6].
وفي نفس أيام صدور تلك الدراسة نشرت صحيفة ''ذي هيرالد تريبيون'' مقالة مهمة لكينيت بولاك، كبير الباحثين العلميين في (Brookings Institution's Saban Center for Middle East Policy)، ومؤلف كتاب ''الطريق من الصحراء: استراتيجية كبرى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط'' يحذر فيها من ''الصدمة النفطية الثالثة[7]'' التي تبدو موجعة للاقتصاد الأميركي، إلا أنها على حد قوله ''ستحفزنا للعمل على التخلص من الاعتماد على النفط. وعلى المدى البعيد يمكن أن تصبح نعمة كبرى بالنسبة لاقتصادنا وبيئتنا وأمننا الوطني''. لكنه يحذر بلدان الشرق الأوسط من عكس ذلك تماما. فهي تعيش الآن انتعاشا اقتصاديا وتجد إمكانات لحل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي أدت إلى نبت منظمات إرهابية فيها كالقاعدة. لكن الخطورة تكمن في أن الطرق المتبعة لاستخدام العائدات المتنامية باستمرار يمكن مع الوقت أن تؤدي تماما إلى تزايد عدم الاستقرار في هذه المنطقة.
تجربة السبعينات والثمانينات بينت أن هذه البلدان استخدمت عائدات النفط جزئيا لدعم برامج الرعاية الاجتماعية، بينما وجهت القسم الأعظم للاستثمارات في الممتلكات غير المنقولة في الخارج وللإيداع في المصارف السويسرية. ولم تستثمر بشكل مجد لتنويع الاقتصاد الوطني. ولذلك فعندما تحولت الطفرة إلى انهيار بدأت المشاكل الاقتصادية تنمو. ومعها تعاظم التململ السياسي والإرهاب.
هذه المرة يبدو أن المليارات تستثمر في الداخل بإنشاء فروع صناعية وبتحسين شبكات الطرق والمصانع وتوسيع مجال الخدمات الاجتماعية. لكن الكاتب يسجل أن هذه الأموال توظف ليس حيث الحاجة، بل حيث الربح الأسرع وحيث لا تحلب منافع سياسية واقتصادية على المدى البعيد ما سيخلق مشاكل في المستقبل. وكذلك في صناعة تكرير النفط أو الصناعات ذات التقنيات العالية القائمة على الأتمتة التي توفر فرص عمل كافية. أما القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة فتجلب هذه العمالة من دول جنوب شرق آسيا. وتشكل العمالة الأجنبية 80 - 95% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. لكنها بدأت هي الأخرى تنشط في حركة احتجاجية من أجل تحسين الأجور وظروف العمل والسكن والضمان الاجتماعي. ويجري استثمار مزيد من المال في توسيع التعليم، لكن ليس في إصلاح حقيقي للتعليم، حيث يواجه الخريجون منغلقا في سوق العمل. وهكذا قد تبدو مؤشرات الاقتصاد الكلي (الماكرو) رائعة، لكن البطالة تتراجع ببطء والتضخم يتزايد بوتيرة عالية. أما المشاكل الجدية على مستوى الاقتصاد الجزئي ( الميكرو) فتشوه لوحة الماكرو الزاهية.
الارتفاع المحموم في أسعار المواد الغذائية ومواد الطاقة والخدمات يدفع بمستويات التضخم إلى مستويات مرتفعة. وكالعادة يوجع التضخم الفئات الوسطى والدنيا في المجتمع، لتتسع الفئات الدنيا بتسارع. سياسيا يشكل ذلك تربة خصبة لانتعاش التطرف والتذمر من الأنظمة القائمة. وقد يؤدي رفع الأجور إلى تهوين مشاكل التضخم بالنسبة لموظفي الدولة مؤقتا، لكنه سيرفع مستويات التضخم لاحقا ولا يمكن أن يحل المشاكل الاقتصادية البنيوية بأي شكل.
في حمى التهافت من أجل الحصول على العطاءات و''المناقصات'' تفتح أوسع قنوات الرشاوى، ما يعمق مظاهر الفساد ومعه أزمة أخلاقية في المجتمع. ويجري تبديد الأموال على كل ما ليس له داع. وتفتح صفقات تكديس الأسلحة قنوات استنزاف واسعة.
من جانب ثالث تشير ''لوس أنجلوس تايمز'' إلى أن أسعار النفط الخيالية عززت مواقع الأنظمة الأوتوقراطية في المنطقة وجرأتها من جديد على تحدي الاتجاه العالمي والعودة إلى كبح الحركات الديمقراطية في الداخل. لكنها تنبه إلى أن الإمكانات المالية الضخمة المتوافرة لدى هذه الأنظمة تحمل في طياتها مخاطر داخلية جمة. ارتفاع مستويات التضخم يمكن أن يؤدي إلى تدني هيبة الحكومات لدى السكان[8]. بلسان الأجانب تحدثنا، فلعلهم مسموعون أكثر!